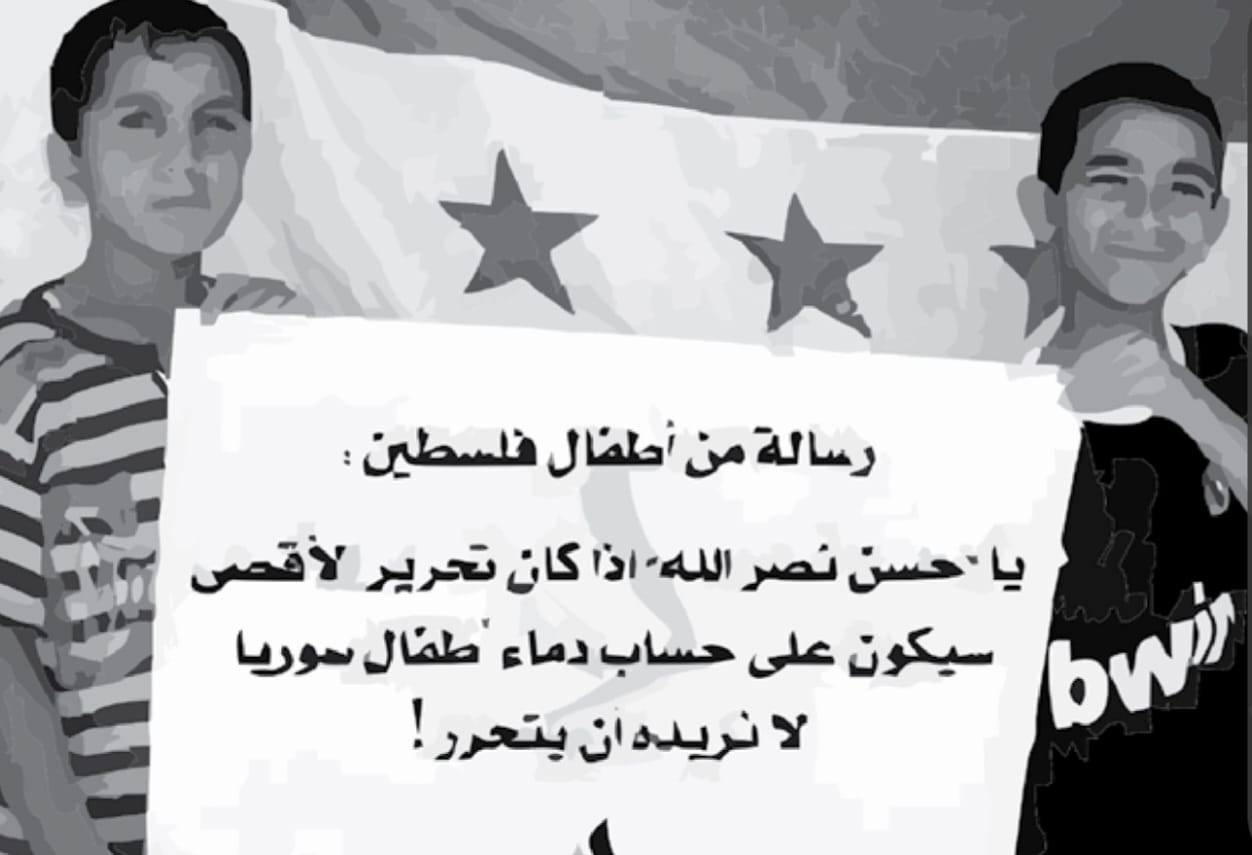أنيس محسن
إن دور الفلسطينيّين فيما يجري في سوريا ليس محورياّ، لكنّه في الوقت ذاته ليس خارجا عن السياق الطبيعيّ والمنطقيّ للأمور. وبغضّ النظر عن موقًف القوى السياسيّة الفلسطينيّة؛ سًواء المؤيدّة للثورة أو للنظام أو النائية بنفسها عمّا يجري، فإنّ الفلسطينيّين مزجوجون في أتون ما يحصل تبعا لانخراطهم شبه الكامل في الحياة العامّة السوريةّ: الاجتماعيّة والاقتصاديةّ بل وحتىّ السياسيّة، لكنّ دورهًم في الحرب الدائرة ليس مقرِّرا أو مؤثرِّا وإنمّا هامشيّا. وفيما لا خوف على مستقبلهم اجتماعيّاً واقتصادياّ في سوريا، فإنّ الانعكاساتً المحتمًلة )سلبيّة كانتً أو إيجابيّة( سوف تكون على القضيّة الفلسطينيًّة بشكل عام.
معلوم أنّ الفلسطينيّين سعوا أساسا إلى عدم وضع تجمّعاتهم الكبرى، مثل مخيّم اليرموك، في عين عاصفة القتال الدائر، وجعلوا من تجمًّعاتهم تلك، أو أملوا في أن تكون، ملاذا آمنا لكّلّ الجوار السوريّ؛ إليه يهرب الأطفال والنساء والشيوخ من الأتون الملتهب، وفيه يتطببّ الجرحىً والمًرضى. لكنّ الأمنيات تبقى في عالم افتراضيّ والواقع على الأرض هو من يفرض نفسه، إذ تحوّلت تلك الملاذات التي أرادها المدنيّون السوريوّن قبل الفلسطينيّين كذلك، إلى بؤر اشتباك؛ أولاً بسبب إقدام «فلسطينييّ النظام» من أمثال الجبهة الشعبيّة ـ القيادة العامّة على تشكيل لجان شعبيّة، بذريعة حماية المخيّمات، وبحقيقة دعم النظام؛ وثانياً بعدما استخدمها جيش النظام للانقضاض على «الجيش الحر» في الجوار السوري لمخيّم اليرموك، ما دفع «الجيش الحرّ» وقوى أخرى من المعارضة المسلحة إلى دخول المخيّم، وبالتالي خسارة هذا الملاذ الآمن الذي لم يكن النظام راضيا عن كونه ملاذا.
أمّا الفصائل التي وقفت ضد القمع السلطويّ للتًظاهرات السلمًيّة في بداية الثورة؛ خصوصاً حركة «حماس»، فلها غاياتها وأسبابها. فـ «حماس»، صديقة النظام والعضو في «محور الممانعة» هي امتداد لجماعة «الإخوان المسلمين»، وبالتالي فإنهّا تنتظم في نهاية المطاف ضمن الخيار الاستراتيجيّ للجماعة ،وإن احتفظت لذاتها بتكتيكات هنا وأخرى هناك. لقد سعت «حماس» في بداية الأمر إلى الحفاظ على علاقتها بالنظام من دون أن تتنكّر لشارعها المؤيدِّ، أيديولوجيّا وعقائدياّ وطائفيّا للمعارضة في شقّها الإسلاميّ السنّيّ، لكن ما طلبه النظام منها كان موقفا واضحا: معً النظام أوً ضدّه. وًكونها لا تستطيع أن تكون مع النظام، فإنّ هذا النظام صنّفها في خانة الخًصوم، وًصولاً إلى قطع حبل السرّة بينهما وخروجقيادات الحركة من سوريا .
بين «حماس» و «القيادة العامّة» تقف فصائل منظمّة التحرير: «فتح» الحائرة في الموقف؛ بين خصامها التاريخيّ مع نظام آل الأسد، ورسم نظام الأسد الابن خطوطاً جديدة للعلاقة بينهما عبر إعادته أخيراً مراكز لـ «فتح» كان سلمّها إلى «فتح الانتفاضة» في سنة 1983 عندما عمد النظام إلى شقّ الحركة وطرد ياسر عرفات مرةّ ثانية من لبنان بعدما كانت إسرائيل أخرجته عقب غزوها لبنان في 1982؛ وبين بحثها عن حلفاء يؤازرونها في تنافسها مع «حماس» بعدما فقدت الدعم المقدّم من مصر «مبارك» وتونس «بن علي» وتخليّ الغرب وخصوصا واشنطن عنها وتملصّ إسرائيل من اتفاقات أوسلو، في مقابل الدعم الكبير الذي تلقاه «حماس» من مصًر «الإخوان» وتونس «النهضة» ومن قطر الجانحة نحو «الأخونة ،»وذلك لإحلال «حماس» مكان «فتح» في قيادة الفلسطينيّين. وفي هذا السياق تنظر «فتح» بريبة إلى اقتراح عقد قمّة عربيّة مصغّرة للمصالحة الفلسطينيّة، خلال القمّة العربيّة الأخيرة في الدوحة، من دون الأخذ برأي منظمّة التحرير الفلسطينيّة ـ العضو في الجامعة العربيّة ـ بل تجاهل موقع المنظمّة كممثلّ شرعيّ ووحيد للشعب الفلسطينيّ، ووضعها على قدم المساواة مع «حماس» وبالتالي طرح شرعيّة التمثيل الفلسطينيّ على بساط البحث في محاولة لتحويله من منظمّة التحرير «العلمانيّة» إلى حماس «الإخوانيّة» كحلقة من حلقات سلسلة الحكم «الإخواني» على المستوى العربيّ.
أمام هذا الواقع، يلُاحَظ أنّ قيادة فتح تبدو مياّلة لاستخدام الخصومة المستجدّة لنظام الأسد مع «حماس» والحلف الإقليميّ «الإيرانيّ ـ السوريّ» وامتداداته الروسيّة والصينيّة، لمواجهة المحور المستجدّ «الإخوانيّ» من جهة، والضغوط الرسميّة العربيّة – الغربيّة – الإسرائيليّة لاستجرار المزيد من التنازلات مثل تعديل مبادرة السلام العربيّة أخيرا. لكنّ «فتح» تبقى حذرة كون حلف «الممانعة» كان من ألدّ خصومها، خصوصا دور نظام الأسد في اًنشقاق «فتح الانتفاضة» في 1983، والدعم الإيرانيّ الماليّ والتسليحيّ غير المحًدود لـ «حماس» في غزةّ الذي كان واحدا من العوامل التي مكّنت الأخيرة من طرد «فتح» من القطاع في حزيران 2007. بينما يجد كادر الحركًة في سوريا نفسه مع المطالب المحقّة للشعب السوريّ، وكان منهم معتقلين وشهداء.
وفي الخارطة السياسيّة الفلسطينيّة إزاء الصراع في سوريا، هناك الجبهتان الديموقراطيّة والشعبيّة: الأولى تتخذ من دمشق مقرّاً رئيسيّا لقيادتها، لكنّها لا تنبس ببنت شفة عن هذا الصراع مع ميل أكبر لتأييد النظام؛ والثانية الحائرة بين ضغًط النظام عليها من خلال التهديد المباشر أو المبطنّ بإعادة النظر بتواجد بعض قياداتها في دمشق وبين ميل قسم لا بأس به من أنصارها في سوريا نحو تأييد الثورة السوريةّ.
وبغضّ النظر عن مواقف الفصائل الفلسطينيّة، فإنّ اندماج اللاجئين الفلسطينيّين في سوريا اجتماعيّاً واقتصادياّ وسياسيّا، يجعلهم جزءاً مما يجري بإرادتهم الكاملة. فبعضهم وقف مع النظام، وبعضهم الآخر انخرط تمًاما في الًحراك الشعبيّ، وقسم منهم كان من منظمّي التنسيقيّات وقيادات المجالس الثوريةّ .
أمّا سبب انقسًام اللاجئين الفلسطينيّين في سوريا بين مؤيدّ للنظام ومعارض فأفترض أنهّ يمكن تلخيصه بـ:
1 – ظهرت حالة التأييد حيث لم يكن هناك تشابك بين الفلسطينيّين والسورييّن، ودائما كانت تنتج عن حالة من التعايش بقوى سياسيّة بعينها. وفي حالات كانت من جنس نظيرها في اًلحالة السوريةّ ،حيث كانت خوفا من النظام، وتذمّرا من الأخطاء التي ارتكبتها كتائب مسلحّة، أكثر منها تأييدا له .
2 – معارضو النظام يسًكنون أساساً في الًمناطق التي فيها اختلاط كبير بين الفلسطينيّين والسورييًّن ،مثل مخيّم اليرموك الذي يفوق تعداد سكّانه مع محيطه المباشر مليون نسمة، نحو 200 ألف فقط منهم فلسطينيّون. وكذلك هم موجودون في تجمّعات أو داخل الأحياء في مدن وبلدات وقد لعبوا ويلعبون دورا فيما يجري، كما هو حاصل في مخيّم اليرموك ومخيّم حمص وفي دوما في ريف دمشق، ومناطًق أخرى.
3 – إنّ الفلسطينيّين بشكل عامّ جزء من المجتمع السوريّ يخضعون للضغوط نفسها ويزدهرون إذا ازدهرت البلاد، ويؤيدّون ويعارضون، مثلهم مثل السورييّن، وللأسباب ذاتها تقريبا.
والمعلوم أنّ اللاجئين الفلسطينيّين في سوريا يمتازون بأنهّم يمتلكون كّلّ الحقوق ما عًدا حقي الترشح والانتخاب )ولا يمتلكون حقّ تملكّ أكثر من شقّة سكنيّة واحدة( وعليهم كّلّ الواجبات، كما أنهّم يتماهون اجتماعيّا مع المجتمع السوريّ، وينخرطون في العمليّة الاقتصاديةّ كتجّار وعمّال ومستثمرين ،ولهم الحقّ في التًوظفّ في القطاع العامّ، حتىّ مرتبة وكيل وزارة )وهو ما تمّ سحبه منهم في زمن الثورة، إن عبر قرار استثنائهم في التوظيف في التربية بقرار، أو المرسوم من الرئيس السوريّ، أو عبر التوقفّ عن ذكرهم في الإعلانات الرسميّة للدولة عن الوظائف كما كان يحصل عندما كان يضاف لـ «السورييّن» مصطلح «ومن في حكمهم» الدالّ عليهم(. وبالتالي فإنّ هذا الانخراط يجعلهم جزءا لا يتجزأّ عن المجتمع السوريّ، يتفاعلون معه بغضّ النظر عن موقف الفصائل الفلسطينيّة. كما أنّ جزًءاً لا بأس به من الشباب الفلسطينيّ هم أعضاء في أحزاب سوريةّ أو يتفاعلون في وسطها ومع أفكارها.
لكن أيضا بغضّ النظر عن اصطفاف البعض، الأقلويّ، إلى جانب النظام، وتفاعل البعض الآخر، الأكثريّ، في الثورة ضدّ النظام )بالمشاركة أو عبر التأييد( منذ انطلاق التظاهرات السلميّة في الأشهر الستةّ الأولى، فإن دور الفلسطينيّين يبقى هامشيّا في مسار وسيرورة الأزمة السوريةّ. فمجمل عدد اللاجئين الفلسطينيّين لا يتجاوز 500 ألف من أصل نحًو 24 مليونا. والقضيّة الفلسطينيّة، التي لطالما رفعها النظام فزاّعة أمام كّلّ من يفكّر في معارضته، ليس عنصراً من عًناصر الانتفاضة ضدّ النظام، تماماً كما هو عليه الأمر في تونس وليبيا ومصر واليمن.
وإذا كان مستقبل الوجود السكانيّ الفلسطينيّ في سوريا غير معرّض للخطر، كون الفلسطينيّين مندمجون في المجتمع السوريّ غير مميزَّين عنه ولا مهمَّشين، فإنّ المستقبل السياسيّ لقضيتهم قد يكون أمام تحدّيات جديةّ.
لقد لعبت سوريا على مدى تاريخ الصراع العربيّ ـ الإسرائيليّ دورا محورياّ، فكانت قبلة الثوار خلال ثورة 1939 – 1936 في فلسطين؛ منها يجلبون السلاح، ومنها يأتيً كثير مًن المتطوّعين بل والقادة من أمثال الشيخ عزّ الدين القسّام ابن بلدة جبلة في الشمال السوريّ الذي استشهد في سنة 5391، واعتبُر استشهاده تمهيدا لثورة 1936. وفي مرحلة ما بعد النكبة في سنة 1948، كانت سوريا كمرجل تغلي بداخله مشاعر رفضً الهزيمة وتنبت في حقلها المشاعر القوميّة، تلك المشاعر التي مكّنت حزب البعث من الاستيلاء على السلطة كردّ على «تخاذل» الأنظمة القائمة في حينه إزاء القضيّة الفلسطينيّة ،في سوريا وخارجها. وكانت سوريا في مطلع الستينيّات وأواسطها الأرض الحاضنة للثورة الفلسطينيّة المسلحّة، حيث انتشرت فيها قواعد الفدائيّين؛ من الجولان إلى دمشق وريفها والحدود اللبنانيّة ـــ السوريةّ وصولاً إلى الشمال السوريّ بساحله وجباله. وحظيت الفصائل الفلسطينيّة بكّلّ الدعم غير المشروط من قبل النظام والشعب في سوريا، إلى أن بدأ الواقع يتغيّر مع انقلاب وزير الدفاع حافظ الأسد ورئيس الأركان مصطفى طلاس في 16 تشرين الثاني 1970 الذي أطُلقت عليه تسمية «الحركة التصحيحيةّ» وتوليّ الأسد الرئاسة في 1971، والتي كان أوّل معالمها فلسطينيّا؛ً سحب القوّات السوريةّ التي دخلت إلى الأردن لمؤازرة الفدائيّين وكشف ظهرهم ممّا سهّل على الجيش الأردنيّ كسب ما يعُرف بمعارك أحراش جرش وعجلون. ومن ثمّ الانقلاب على التحالف القائم بين النظام السوريّ وبين منظمّة التحرير والحركة الوطنيّة في لبنان بقيادة كمال جنبلاط في 1976 والدخول الى لبنان تحت ذريعة الدفاع عن المسيحيّين فيه بموافقة أميركيّة – إسرائيليّة – عربيّة، واستكمال مشروع الهيمنة على الفصائل الفلسطينيّة من خلال إحداث انشقاق في حركة «فتح» في سنة 1983 في خضمّ خوض حرب عصابات ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ في الجبل والجنوب، وصولاً إلى مساعي إضعاف التمثيل الشرعيّ لمنظمّة التحرير للشعب الفلسطينيّ، ودعم «حماس» ضدّ «فتح» في زمن الأسد الابن.
لكن على الرغم من كّلّ الأدوار السلبيّة التي اضطلع بها نظام آل الأسد، فلسطينيّا، فإنّ سوريا قبل حكم العائلة، وخلاله، كانت إمّا ملاذا فلسطينيّا وأرضا حاضنة للفدائيّين وللفصائل، أو مترًاساً سياسيّا تستخدمه منظمّة التحرير، وخصوصا الرئًيس الراحًل ياسًر عرفات، لمواجهة الضغوط الغربيّة والعربيًّة لتقديم تنازلات كبرى، إذ كانت المًواقف السوريةّ «الممانعة» ذريعة لرفض تقديم هذه التنازلات، ومناورة تسُتخدم للقول إنّ في سوريا ملاذا آخرا إذا ما تواصلت الضغوط.
إنّ الخشية هي أنّ الهموم الداخليًّة، فيً سوريا في المرحلة المقبلة كما في مصر وتونس مثلاً، سوف تطغى على أيّ قضيّة خارجيّة أخرى، بما فيها القضيّة الفلسطينيّة، وبالتالي لن تكون سوريا بعد ذلك ،ولزمن غير معلوم، الحاضنة للحراك الفلسطينيّ السياسيّ أو المسلحّ، كما لن تكون عنصر المناورة «الممانع» الذي كان يتلطىّ خلفه عرفات عندما يريد الحدّ من الضغط عليه، وهذا الأمر سوف يكشف الواقع الفلسطينيّ، ويجعله عرضة لضغوط أكبر: أميركيّة – إسرائيليّة على «فتح» من أجل نزع ورقة التوت الأخيرة والتنازل عن كّلّ الحقوق، أو ضغوط «عربيّة / إخوانيّة» على «حماس» كي تتنازل، وهي عمليّا باشرت التنازلات عبر القبول الضمنيّ بحّلّ الدولتين ولو تحت غطاء هدنة طويلة الأمد، وذلك لتثبيتً دعائم حكم الإخوان عربيّا بموافقة دوليّة.
هذا التحليل ينطبق على بعض احًتمالات المستقبل في سوريا: نجاح النظام في قمع الثورة وبالتالي الانتقام من الفلسطينيّين المنخرطين بمعظمهم مع الثورة أو المؤيدّين لمطالبها و/أو تقديمهم ضحيّة على مذبح العودة إلى المجتمع الدوليّ؛ نجاح الثورة وانهيار نظام الأسد وحاجة سوريا إلى إعادة البناء ورضوخها للضغوط الدوليّة، وسياسيّاً عبر وضع القضيّة الفلسطينيّة في خلفيّة المشهد، في مقابل المساهمة في إعادة الإعمار؛ فرض نوع من الستاتيكو التقسيميّ غير المعلن بين الساحل السوريّ وجباله، وأنحاء البلاد، وبالتالي غياب أيّ تأثير لسوريا «الدولة المركزيةّ» كلاعب إقليميّ.
وأولاً وأخيراً فإنّ احتمال فقدان سوريا كدرع للفلسطينيّين، سببه هذا الاستخدام الطويل والمفرط للقضيّة الفلسطينيّة خصوصاً من قبل نظام الأسد، بهدف تقويض أيّ معارضة للنظام؛ والتهمة الجاهزة كانت على الدوام تقويض قدرة النظام على مواجهة إسرائيل، وهي خيانة لطالما تسبّبت بسجن أو طرد المعارضين ،بل وحتىّ قتلهم، إلى درجة أضعفت الدعم الشعبيّ للقضيّة الفلسطينيّة الذي كان فطُِمَ السوريوّن عليه منذ عزّ الدين القسّام إلى ما قبل تغوّل النظام على شعبه وارتكابه المجازر التي راح ضحيّتها حتىّ الآن ما يدنو من مئة ألف قتيل. ولكن في التلاحم الشعبيّ بين الفلسطينيّين والسورييّن في زمن الثورة، تضامناً وتكافلاً، وفي حالات مشاركة، ينفتح احتمال إعادة تصويب العلاقة